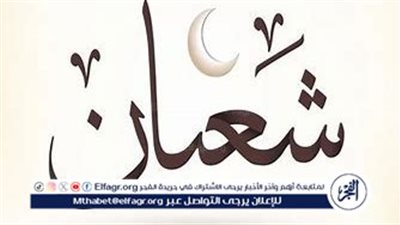حكم إحرام من دخل مكة دون نية العمرة ثم أراد أداءها

حكم إحرام من دخل مكة دون نية العمرة ثم أراد أداءها.. ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤالًا من أحد الأشخاص حول حكم الإحرام لمن دخل مكة المكرمة دون نية أداء العمرة، ثم قرر بعد ذلك القيام بها.
وأوضح السائل أنه سافر إلى مكة لزيارة ابنته، ولم يكن ينوي أداء العمرة عند دخوله، لكنه بعد وصوله رأى أنه من المناسب اغتنام الفرصة لأداء هذا النسك، فتساءل: هل عليه الرجوع إلى ميقات بلده للإحرام، أم يمكنه الإحرام من داخل مكة؟ وهل يترتب عليه دم في هذه الحالة؟.

حكم الإحرام لمن دخل مكة دون نية العمرة
أجابت دار الإفتاء قائلة: إن من دخل مكة المكرمة دون إحرام، وكان ذلك لزيارة أقاربه أو لأي غرض آخر غير أداء العمرة، فإنه يجوز له الإحرام من ميقات أهل مكة، تمامًا كما يفعل المقيمون فيها.
وفي هذه الحالة، يتوجه إلى أقرب موضع من الحِلّ، مثل التنعيم، ثم يحرم بالعمرة منه، دون الحاجة إلى الرجوع إلى ميقات بلده.
كما أكدت الدار أنه لا يلزمه دفع كفارة أو دم بسبب دخوله مكة دون إحرام، ما دام لم يكن ينوي أداء العمرة عند وصوله.
معنى الإحرام وأهميته في الحج والعمرة
الإحرام هو النية للدخول في مناسك الحج أو العمرة، وسُمِّي بهذا الاسم لأنه يقتضي الامتناع عن بعض الأمور التي كانت مباحة قبل الدخول فيه، مثل لبس المخيط واستخدام العطور.
كما يرتبط الإحرام بالحرم المكي، وهو جزء أساسي من أداء المناسك، إذ لا يجوز للحاج أو المعتمر تجاوز ميقات الإحرام دون اتخاذ هذه النية.
المواقيت الزمانية والمكانية للإحرام
للإحرام بالحج والعمرة مواقيت زمانية ومكانية محددة:
المواقيت الزمانية: يُحدد الشرع فترة زمنية للإحرام بالحج، تبدأ من شهر شوال وتمتد حتى العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، وهذه الفترة تُعرف بأشهر الحج، أما الإحرام بالعمرة، فيمكن أداؤه طوال العام دون ارتباط بوقت معين.
المواقيت المكانية: هي المواقع التي حددها النبي ﷺ كمنافذ للإحرام قبل دخول مكة، حيث يجب على من يمر بها بنية الحج أو العمرة أن يحرم منها، وهذه المواقيت تختلف حسب الجهة التي يأتي منها الحاج أو المعتمر، وهي:
- ذو الحُليفة: ميقات أهل المدينة، ويُعرف اليوم بـ "أبيار علي".
- الجُحفة: ميقات أهل الشام ومصر وتبوك، ويُعرف حاليًا بـ "رابغ".
- قرن المنازل: ميقات أهل نجد والطائف، ويُعرف اليوم بـ "السيل الكبير".
- يلملم: ميقات أهل اليمن، ويُعرف اليوم بـ "السعدية".
- ذات عِرق: ميقات أهل العراق، وهو غير مذكور في الرواية ولكنه ثابت فقهيًا.
أما من كان داخل مكة وأراد أداء العمرة، فميقاته أدنى الحِلّ، أي أقرب مكان خارج حدود الحرم، مثل التنعيم، وهو المكان الذي أحرم منه النبي ﷺ للسيدة عائشة رضي الله عنها عندما أرادت أداء العمرة.